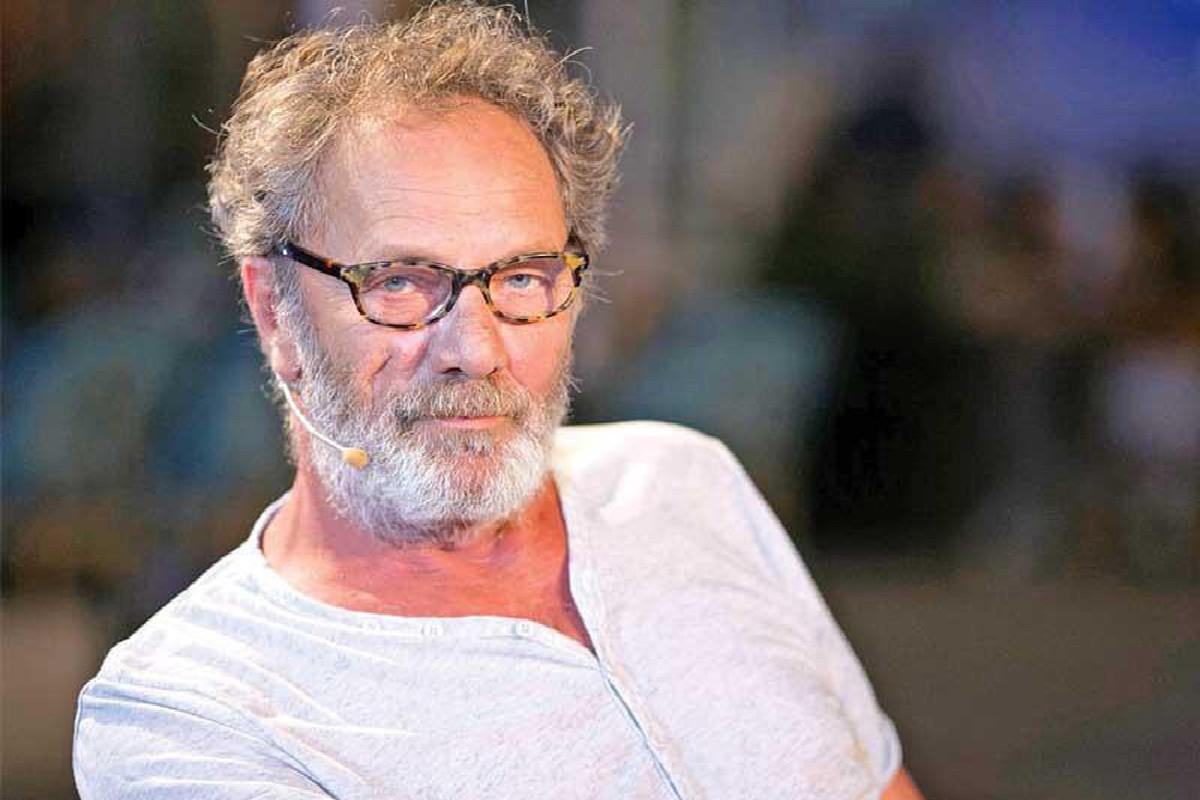حين يتقدم الشاعر نحو الشعر بعد غياب، فإن اللغة تستقبل خطاه بوصفه القادم من الرماد. لا يعود كما غاب، بل يعود وفي يده جمر من التجربة، وركام من الرؤية، وحنجرة أدمنها الصمت حتى أصبحت تعرف كيف تصرخ دون أن تعلو. وهكذا عاد حميد سعيد، بعد سنوات من العزلة النبيلة، لا ليقول، بل ليشهد. لا ليرثي فقط، بل ليكشف، ويسائل، ويستحضر، ويستنطق الحجر والأنقاض والسكوت العربي الطويل.
في قصيدته "الموت في غزة"، يخرج حميد سعيد من صومعته ليكون شاهدا أخيرا على فصل دام من فصول التاريخ الفلسطيني، لا بوصفه مؤرخا، بل بوصفه شاعرا يرى بعين القلب، ويكتب بقلم المجاز، ويشهر ضد الوحشية ما بقي له من نشيد. هذه القصيدة ليست مرثية لغزة، ولا تأبينا لأهلها، بل هي مرآة سوداء تنكسر فيها صور العالم، ليولد منها صوت الحقيقة المجروحة، تلك التي لا تقال في نشرات الأخبار، بل في لجة الشعر.
وحده الشاعر الذي تمرس في وجع الأمة، وتشرب وعيها الجريح، يستطيع أن يلتقط بعين البصيرة جناح الموت حين يرفرف في سماء المدينة، وأن يحدق فيه لا ليفك شفراته فحسب، بل ليقاومه بالكلمة. "للموت أجنحة" يقول، ثم يمضي يتعقب مسارها في تفاصيل الحياة اليومية، في الأشجار التي لم تعد تتواصل، في العجين الذي ضل الطريق، في الجمر الكامن في الأرحام، في صمت الأمهات وصراخ الفتيات وندبة الأرض.
لا تكتفي القصيدة بوصف المحنة، بل تسائلها، وتحاكمها، وتعيد ترتيب مشهد الدم والخذلان ضمن منطق شعري صارم: يتجاوز التوثيق إلى التأويل، ويتخطى الحزن إلى استدعاء المعنى من بين الأنقاض. في غزة، كما تقول القصيدة، لم يقتل الناس فقط، بل اغتيلت الحكايات، وغادر الخبز المدينة، وهدمت المشافي، وهرب الشجر، وتحول الوطن إلى سؤال مشتبك مع الصدق والخديعة، مع البطولة والخيانة، مع النبوءة واليأس.
لكن في غمرة هذا الخراب، لا يسقط الشاعر في فخ الرثاء الاستسلامي، بل يستبقي بصيصا لا يطفأ: غزة، كما يؤكد، لن تمضي، بل ستظل هناك، في قلب الموت، وفي ذاكرة التراب، كأنها قدر يعاد، وكأنها نذور الدم التي تفتدى بها الكرامة.
إن هذه القصيدة، بما فيها من صور شعرية باذخة، ورمزية مكثفة، وإحالات تاريخية وإيمانية وسياسية، تجسد لحظة فارقة من التقاء الرؤية الشعرية بالضمير القومي، وتحيل القارئ من مجرد التلقي إلى مواجهة سؤال: كيف نكتب الشعر في حضرة المجزرة؟ كيف ننقذ الكلمة من تواطؤها مع البلاغة، وننقذ المعنى من انكساره تحت وقع الحقيقة؟
بهذه القصيدة، لا يعود حميد سعيد إلى الشعر، بل يعود ليقيم فيه مقاما آخر، مقاما تتساوى فيه اللغة مع الألم، وتغدو فيه القصيدة تابوتا يحمل موتى غزة إلى ضمير العالم، أو جرحا مفتوحا يذكرنا، كلما حاولنا النسيان، أن هناك شعبا يموت.. كي لا يموت.
**
للموت أجنحة ..
يطير بها إلى من لا يشاء .. ومن يشاء من الضحايا..
في الطريق إلى التي كانت تشاكسه..
فتنجب كل عام ..
حط حيث رأى صغارا يكبرونْ
وفي بيوت مدينة كانتْ
تكاثرتْ القبورْ..
وتطلع الموتى إليها..
ليس من باب سيغلق دون من جاؤا إليها ..
رحم ثري منذ أن كانتْ
تجمع حولها وطن جميل
للموت سطوته ولكن الحياةْ
أقوى إذا اشتبكا
يفتتح حميد سعيد بنبرة شبه أسطورية تجسد الموت ككائن له "أجنحة"، قادر على أن يختار أو لا يختار، مازجا بين الإرادة العمياء والقدر المحتوم. هذا التصوير الرمزي يجعل من الموت طائرا خرافيا يحلق بحرية فوق المكان الفلسطيني، وتحديدا "غزة"، ليحط بين البيوت، حيث الصغار يكبرون - صورة مفجعة تقابل الحياة بالموت وجها لوجه.
المدينة التي كانت "تشاكسه" - في إحالة إلى الحياة، الحب، الخصوبة، والضحك المقاوم - أصبحت الآن حقلا للقبور. ورغم ذلك، يؤكد حميد على أن "الحياة أقوى إذا اشتبكا"، وهنا يكمن التحدي: أن يكون الإنسان خصما عنيدا في وجه الموت. البعد الرمزي في وصف غزة كـ"رحم ثري" تفتح الدلالة على خصوبة المقاومة وتجذرها في الأرض والتاريخ، وتحول المكان من ضحية إلى مولد للحياة، حتى في ظل المجازر.
***
لماذا .. لمْ تعدْ تتواصل الأشجار..
مذْ غطى الرماد.. الأرض
وانتشر الدم..
الجوع .. افترى أنشودة سوداء..
واختار الصبايا الحالماتْ..
عرائسا
والأمهاتْ..
يطعمن من وشل .. جموع الجائعين ْ
المشهد يتحول إلى لوحة سريالية قاتمة، حيث الأشجار تقطع تواصلها، والرماد يعلو الأرض، والدم ينتشر، وكأننا فيما بعد الكارثة. الجوع يتحول إلى كائن خبيث يفتري أنشودة الموت، ويختار "الصبايا الحالمات" لتكن "عرائس"، في إحالة دموية إلى الشهداء من الفتيات. أما الأمهات، فتظهر في صورة مأساوية سامية: يطعمن جموع الجائعين بما يشبه الندى أو الوحل - رمزا للفقر المدقع، ولكن أيضا لصمود الكرامة الأنثوية في زمن الانهيار.
***
اختفت البيوت .. وغادر الخبز المدينة..
ضيع الطرق التي كانت ، إلى الناس .. العجينْ
الجمر في الأرحام .. يخرج مستفزا..
منْ سيأخذه إلى مشفى ؟!
وقد هدم المغيرون المشافي ..
ما كان من شجر يطل من الحقول..
ذوى..
ولم ثيابه .. ومضى
وأبقى في التراب وللتراب..
رسالة للقادمين ْ
هنا تبلغ المأساة ذروتها: اختفاء البيوت كناية عن تدمير الحياة، وهروب الخبز ـ رمز القوت اليومي ـ من المدينة، وفقدان الطريق إلى "العجين"، بما يوحي بانقطاع دورة الحياة الطبيعية. صورة "الجمر في الأرحام" توحي بالغضب القادم، بثورة لم تولد بعد، وتقابلها صورة قاسية: لا مشافي، والمغيرون دمروها. تتجلى الرمزية في الشجر الذي "ذوى" و"لم ثيابه ومضى"، كأن الطبيعة نفسها قررت الرحيل من بشاعة المشهد، لكنها تترك "رسالة في التراب" - ترميز للذاكرة، للشهادة، وللأمل الصامت الذي ينتظر من يقرأه.
***
ستعود غز ة مرة أخرى إليها..
تقرأ الآتي ..
ستعرف .. أن من قتلوا..
مضوا..
لكن غزة سوف لا تمضي..
كما كانت .. تظل هناك..
في هذا الخراب ومهرجان الجوع والخوف..
استعادت ما تسلل من طقوس الموت..
في أوراقها الأولى ..
وبادلت الحكايات القديمة .. بالذي يأتي
كأن الموت صياد جبان يقنص الأفراخ..
في أعشاشها ..
ويفر حين يرى الصقورْ
يتحول النص إلى نبوءة. غزة، رغم الجراح، ستبقى، ستعود وتقرأ المستقبل - "تقرأ الآتي". الأفراد يمضون، لكن المكان لا يمضي، بل يبقى شاهدا ومشاركا في الحدث. نلاحظ هنا تكرار فعل "تظل"، ليؤكد الشاعر أن الثبات في وجه الفناء هو جوهر المقاومة.
يبلغ الرمز ذروته في تشبيه الموت بـ"صياد جبان" يقنص الأفراخ ويفر من الصقور - صورة مذهلة تختصر فكرة الظلم، الجبن، واستهداف الضعفاء، في مقابل القوة الكامنة في المقاومة التي لا تقهر.
***
وطن وقورْ
مذ كان تخرج من فيوض يديه ..
أو دمه المهور ْ
أهي النذور ؟
ما كان من عصف يعيد إلى مواسمها..
أقاويل العصورْ
يتحول الخطاب إلى نبرة تأملية: هذا "الوطن الوقور" ليس طارئا، بل "مذ كان"، أي منذ البدء، وهو يقدم من دمه ومن فيض يديه. "الدم المهور" يوحي بالتضحية المشروطة، بالدم كضريبة مقدسة للكرامة. التساؤل "أهي النذور؟" يفتح بابا على قدسية الاستشهاد، كما لو أن الدم نذر الوطن في طقوس خلاصه. ويعود "العصف" - الريح/الثورة - ليعيد المواسم، ملامسا الدورات التاريخية المقاومة.
***
هذا الفجورْ
من أين جاء إليك..
منْ فتح الطريق له ..؟
أما أيقنت . . إن الموت يكمن في دعاوى العاجزين
وإن من كذبوا عليك..
سيكذبون عليك ثانية وثالثة..
سأرجئ ما أريد القول..
لست معاتبا.. وأخاف من زلل اللسان..
يا أنت يا امرأة حصان ْ
كيف استباح حماك.. أوغاد..
يبيعون الكلام ْ
ينتقل الصوت الشعري إلى خطاب مباشر، فيه حزن ومرارة وتساؤل عن أسباب الخذلان، عن من فتح الباب للفجور أن يدخل. تكمن الإشارة السياسية في "من كذبوا عليك" - ربما زعماء أو أطراف تزعم الوقوف مع غزة وتخذلها. الجملة المفصلية: "إن الموت يكمن في دعاوى العاجزين" - تكشف أن الخطر ليس في الأعداء فحسب، بل في العجز والتواطؤ والكلام الفارغ. "يا امرأة حصان" - تعظيم لغزة في صورتها الأنثوية الطاهرة التي انتهكتها خيانات الداخل قبل طغيان العدو.
***
للموت أجنحة..
وأنت قريبة منها .. ومنه
قد تطيلين الإقامة.. بين مقبرة وأخرى..
تدخلين شواهد الموتى..
إلى ما يحفظ التاريخ منها.
تعود القصيدة إلى البداية، إلى المجاز المفتتح: "للموت أجنحة". ولكن الآن، تقرن غزة نفسها بهذه الأجنحة، إذ أصبحت قريبة منها. الإقامة "بين مقبرة وأخرى" تصوير مأساوي مستمر، يوحي بأن غزة تعيش زمنا محكوما بالموت. ولكن رغم ذلك، هناك فعل رمزي مقاوم: إدخال "شواهد الموتى إلى ما يحفظ التاريخ منها" — أي أن الشهداء لن ينسوا، وستوثق تضحياتهم، وهذا فعل مقاومة في ذاته، ضد النسيان وضد الهزيمة.
إن قصيدة "الموت في غزة" لا تقرأ كما تقرأ القصائد، بل ترتل كما ترتل الفواجع التي لا تسعها لغة ولا تحصيها دموع. إنها ليست كتابة على الورق، بل نقش في لحم الجرح، وإملاء من ذاكرة الدم، ورعشة معنى في حضرة صمت عالمي مريب. كتبها حميد سعيد لا ليصفي حسابه مع اللغة، بل ليعيد للقصيدة وظيفتها الكبرى: أن تكون ضميرا يقظا حين تنام الضمائر، وأن تكون صوتا حين يصير الصمت خيانة.
في هذه القصيدة، لا يحتفي الشاعر بالموت، لكنه لا يتهرب من ملامسته، لا يكتفي برثاء الضحايا، بل يستحضرهم ككائنات باقية في الحكاية، ممتدة في ما لم يكتب بعد، جاثمة فوق الخراب، شاهدة على هزيمة الإنسان حين يلوذ بالكلام الفارغ ويترك الدم وحده يكتب المعنى.
هنا، ترتقي غزة من مكان جغرافي إلى مقام وجودي، تتحول من مدينة محاصرة إلى رمز للحياة التي لا يرهبها الموت، ومن ساحة قتال إلى مرآة أخيرة تنعكس فيها صورة العالم: من صدق المقاوم إلى كذب المتخاذل، ومن براءة الضحايا إلى قبح الجلاد. في كل بيت تهدم، وفي كل صبية رحلت، وفي كل أم أطعمت من رمقها الأخير جوعى الليل، ثمة نبض لا يقهر، وروح لا تدفن.
وهكذا تنهي القصيدة قولها، لا بنقطة، بل بندبة، لا بحكمة ختامية، بل بسؤال معلق في الهواء: هل يكفي الشعر ليمنع الموت؟
لا تجيب القصيدة، لأنها تعرف أن الشعر لا يملك الجواب، بل يملك الشهادة، يملك الارتباك النبيل، ويملك القدرة على أن يبقي الألم حيا، لا ليؤلمنا، بل لينقذنا من عادة النسيان.
قصيدة "الموت في غزة" ليست بيانا سياسيا، ولا تكرارا مريرا لمرثية فلسطينية. إنها وقفة نادرة في أعلى مقامات الشعر، حيث يمتزج الجمالي بالوجودي، وتتحول اللغة إلى جسر بين التراب والسماء، بين العدم والإيمان، بين من ماتوا، ومن لا يزالون ينتظرون أن يكتب اسمهم فوق رخام الشهادة، أو فوق سطر في قصيدة.. كهذه.