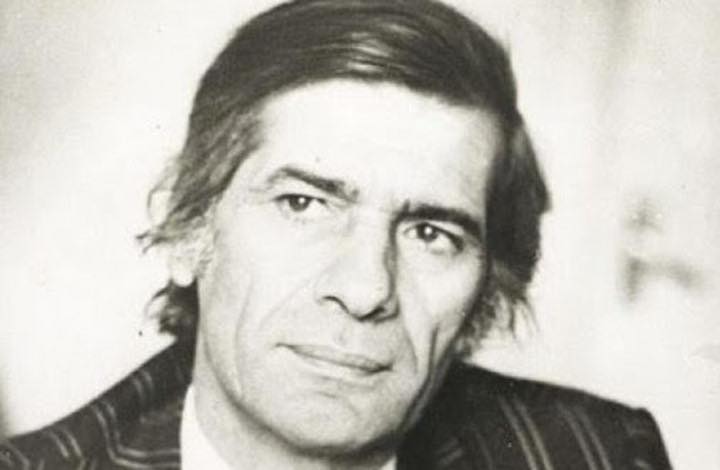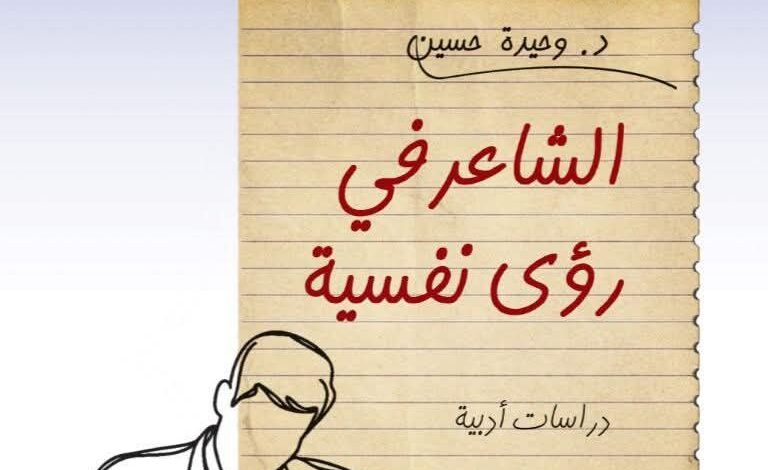يرى "البعض" أن الثورة الفلسطينية التي انطلقت منذ نكبة فلسطين/الأرض وما تلاها، تلاشت مع تعاظم الأدوار السياسية للحكومات الفلسطينية التي جاءت بعد أوسلو، على اعتبار أن هذه الاتفاقية ما هي إلا تحجيم لدور الثوَّار الذين أفنوا حياتهم في دروب الشتات والتشرد حالمين ومتيقنين بعودة وطنهم بلا إذلال أو تأطير. وليس فقط على المستوى السياسي البحت، فقد تبدل حال الثَّوريين سابقا/ داخليا، وارتفع في حسابات بعضهم قمية المادة في ظل تسارع ونمو اقتصادي بتواجد المؤسسات الاقتصادية، فمن كان في البداية يدافع عن الثورة بجميع قادتها وأهدافها، أصبح اليوم يدافع عن الثروة التي قد يجنيها في مشاريع الإسكانات والاستثمارات المربحة في ظروف وجيزة. وهذا الذي يظهر في بداية رواية "السماء قريبة جدا" للكاتب الفلسطيني "مشهور البطران" الصادرة عن دار فضاءات/ الأردن مطلع عام 2016م.
البندقية كتلة من المعدن لا تساوي وزنها خردة، وما يجعلها أداة مقاومة هو الهدف والطريقة التي تستخدم بها، هذه المفارقة تَحَدَثَ عنها بطل الرواية "زيدون الرافعي" ابن قرية الدير جنوب الخليل في الضفة الغربية عندما باع مصاغ زوجته "نبيلة" ليشتري بندقية يدافع بها عن فلسطين، مؤكدا على أن سلاح الثورة هو الكلاشينكوف وليست أي أسلحة أخرى، وأن لا ثورة تدافع عن وطن بسلاح m16 إلا إذا كانت هذه الثورة حليفة لأمريكا "هل يستخدم الثائر سلاح عدوه؟". ويشير "زيدون" أيضا إلى أن أعداء الثورة كُثر، وأن الثورة تلد مؤيِّديها كما تلد أعدائها من أبناء جلدتها. وهنا كانت نقطة انطلاقة زيدون الفعلية بعد قنصه بسلاحه الجديد/الكلاشنكوف رأس ضابط اسرائيلي في مستوطنة قريبة من الدير، ليتبعه بعد ذلك مهمة القضاء على أكبر جواسيس "الشاباك"/ ممن كان لهم اليد في تمزيق نسيج الثورة الفلسطينية .
دياناتُ الرب الواحد
تظهر شخصية المرأة الخمسينية "ميليا" المسيحية الديانة، أثبتت أن رب الأديان لا يفرق بين عباده، أو بينها وبين "زيدون" المسلم، وأن الله يشعر بهم حتى وإن اختلفت الكتب السماوية التي يتقربون إليه منها. وافقت "ميليا" أن يعيش "زيدون" في منزلها مدة تكفي لأن يتعافى من جراحه وقت أن كان مطلوبا القبض عليه بتهمة زعزعة أمن اسرائيل. قابلت صباحته بكثير من الحب والخوف، وكانت النتيجة أن يعود للدير ويتم القبض عليه هناك ويحكم عليه بالسجن مدة ثلاثين عاما. النتيجة المتوقعة لمن يحمل سلاحا موجَّها لدولة احتلال إما القتل أو السجن، وكان الخَيار الثاني هو الذي واجهه "زيدون" بقلب قوي وصبر طويل وأمل لا ينضب سعيا وراء الحقيقة البحتة. من سجنه بدأ يكتب الرسائل لزوجته وأبناءه، وأصدقاءه رفقاء الثورة، ومن أوآه في منزله أيام تشرده_ يقصد هنا "ميليا" _ .
إمرأة واحدة قد تكون جيشاً
خرج "زيدون" في الصفقة المسماة "صفقة شاليط" لتبادل الأسرى، بعد قضاءه عشر سنوات من مدة محكوميته، ليرى الوطن الذي عاش يحلم برؤيته قد تغير، والأولاد أصبحوا شبانا يافعين، والثورة ليست كما كانت أو كما كان يعتقد، والمنزل القديم الذي كان يسكنه قبل وفاة والدته الحاجة " أمينة" أصبح منزلا كبيرا معانقا جبلا من جبال الدير/ جبل العلالي. وجد زيدون بعد خروجه أن امرأة واحدة هي بمثابة جيش في ظهره، انتظرته بكامل طاقتها ملثما تلاقيا لأول مرة، صانت منزلها من الضياع، و بنت بيتا جديدا على طراز فريد جمعهما من جديد بعد أن أصبح حرا، كما أنها عَلَّمت أبنائها وحدها، وأحسنت تربيتهم الوطنية/الثورية. هذا النموذج النسائي الفلسطيني الموجود بكثرة ليس بديلا للرجل أو تشبها بالرجال، وإنما حرصا على عدم القبول بالأداور النسائية العادية، وحتى لا تقف النساء على فجوة النقص وتذبل، البديل لها أن تنطلق لتؤآخي وتناصر وتناضل وتباشر عملها كصانعة مجتمع وليست فقط مُنجبته .
فرصة أخيرة للحياة/للموت
المواقف الوطنية تحتاج لتعزيزها بشكل دوري، لأن من يحاول أن يجد مدخلا يتيح له تنفيذ مخططه فهو الرابح في النهاية. وبتوضيح أدق يحاول جهاز "الشاباك" الاستخباراتي الاسرائيلي الداخلي أن يجند جواسيسا له من بين صفوف الشباب الفلسطينيين، ويحاورهم من جوانب نقصهم. إن لم تكن الثوابت قوية في مواجهة العروض المقدمة راح الشباب وضاعوا تحت جنازر الأوامر "عزت" الإبن البكر لـ " زيدون" كان من ضمن الشباب الذين وضعت أسمائهم على القائمة لتجنيدهم، لكنه وبمساعدة والده، وضع خطة سرِّية ليكون الرابح في النهاية، بدلا من أن يساق وراء القطيع. في المرة الوحيدة/الأخيرة التي استدرج بها "عزت" الضابط الاسرائيلي إلى أحراش قريبة من الدير ليتحدثا في ما يتوجب على "عزت" عمله في المرحلة المقبلة، وبمساعدة والده نصبا كمينا لإصطياد هذا القرش، تم ذلك بعد أن خرجت رصاصة وحيدة من الكلاشينكوف /سلاح والده الذي كان مدفونا في لحده. قتل الضابط "شاؤول" وأصبح عزت مُشردا مُطاردا مَطلوبا.
الدم حين يكتب النهاية
الرواية التي جاءت أحداثها في 223 صفحة، اتضحت النهاية فيها عندما وقف حفيد " هشام الهلالي"/ جاسوس الشاباك، في وجه زيدون في منزله في الدير، جاء ليأخذ بدم جده الذي قتل على يد "زيدون" ورجال الثورة. غرق الأخير في بركة من الدم، في اللحظة التي جاءت فيها سيارات الشرطة الاسرائيلية للقبض على زيدون وابنه عزت، لم يجدوا أمامهم سوى جثة غارقة في دماء الثأر، أخذوها معهم لوضعها في مقبرة الأرقام، وطلبوا من العائلة إخلاء البيت تمهيدا لهدمه. البيت الذي كان يشبه القصور في تصميمه ورواقه، أصبح كومة من التراب، والأم التي صنعت مجد الأسرة نصبت خيمة على أرض منزلها، وزينتها بالأعلام الفلسطينية .